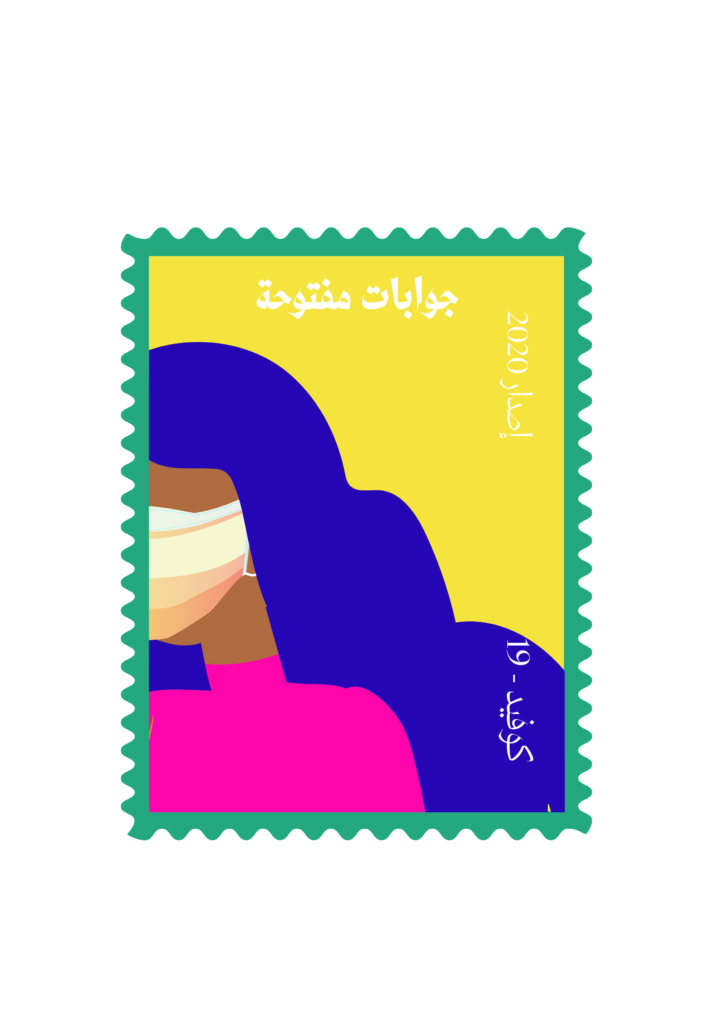كتابة: قسمة كاتول
كاتبة من أسوان
العزا منصوب تلت تيام وبشر من كل ملة
رجال فى الدفانة تسد عين الشمس
صواني الأكل مردومة فوق بعضها… نسوان قاعدة فى الحصيرة صوتهم يوصل لفين وفين
عزا يشرف… اكفينا شر عزا من غير ناس
البكاء أنوثة والعزاء ذكوري
طقوس الموت في بلادي أهم من الموت نفسه
***
العزاء “من غير ناس” والرجال فى طقس الدفن “يتعدوا على الإيد”. لم ينصب عزاء، ولم يكن هناك معزين. توقف الناس عن ممارسة طقوس الموت، أو بالأحرى خافت من إقامتها، فالطقوس ممارسة اجتماعية، كل فئة لها دورها الذي يجب أن تؤديه بكامل التفاصيل. الرجال خلقوا للوقوف وحمل النعوش ونصب العزاء، والنساء للجلوس والولولة. طقوس الموت فى بلادي هي جندرية الفعل والثقافة.
بدءا من إعلان الوفاة حتى “السنوية” وهي مرور سنة. بمناسبة السنة، هي لا يجب أن تمر كـ12 شهرا، بل يجب أن تكون تسعة أشهر، خوفا من أن يصاب أهل المتوفى بشر جراء مواصلة الحزن 12 شهر متوالية، حسب القبيلة التي أنتمي إليها. هناك اتفاق ضمني على تقسيم الممارسات الطقسية للموت؛ الصرخة الأولى لإعلان الوفاة هي ممارسة أنثوية، إعداد “الحصيرة” – وهي مساحات العزاء – مساحة للنساء وأخرى للرجال. وكل فئة عليها إعداد ما يخصها من مساحة، فالنساء فى البيت (بيت العزاء) وجزء ضئيل من الشارع، والرجال فى الديوان/المندرة/الخيمة، وعلى أسوء تقدير الشارع على مساحته. روزنامة الحزن مقسمة إلى “التالتة” مرور ثلاثة أيام، وبعدها ينفض عزاء الرجال وتبقى “حصيرة” النساء. ثم “الخمستاشر” ما زلن النساء في حصيرتهن، ويقمن بتقديم بدعوة للجميع لحضور “ليلة الخمستاشر” وتناول الطعام والشراب. وبعدها “الأربعين”، وأخيرا “السنوية”. وهذه الروزنامة هي ممارسة أنثوية، والرجال دورهم هو تحمل التكلفة المادية لكل “ليلة”. هكذا ظلت طقوس الموت فى الجنوب.
لكن مع جائحة كورونا اختفت الأدوار، وانمحت الروزنامة والبكاء للجميع، والعزاء تم إلغاؤه!
ولم تكن هناك طقوس للموت، بل فقط موت جراء وباء على الجميع الوقاية والاحتراس منه. الممارسات الاجتماعية توقفت لأن المجتمع لم يكن أمامه سوى إنسانيته فقط، إنسانية غير ملتزمة بأدوار اجتماعية.
الممارسات الاجتماعية، كما أوضحت ايمي إس وراتون فى كتابها المعنون بـ “علم اجتماع النوع”، دورها الأساسي هو خلق التباين واللا مساواة بين الأفراد (إناث وذكور).
وعلى أساس تلك الممارسات الاجتماعية، يطالب الأفراد أن يكون سلوكهم فى إطار نسق هذه الممارسات. وأظن أن الوسيلة الوحيدة – وربما السهلة والسريعة – للأفراد
هي التظاهر كلٌ حسب نوعه “البيولوجي”:
التظاهر بالصلابة في مقابل التظاهر بالهشاشة
التظاهر بعدم الاكتراث فى مقابل التظاهر بالحرص
التظاهر بالمعرفة في مقابل التظاهر بالجهل
التظاهر بالشجاعة فى مقابل التظاهر بالجبن
وهذا السياق الضخم والتراكمي من التظاهر خلق أنماطا، وعلى الجميع أن يلتزم بتنميطه
(النبي ما نزلت دمعة على أبوها، واقفة زي الحيطة)
(ياراجل دا بكا على القبور وقت الدفانة، اتجرس والله)
(أنتي هتعرفي أكتر من أخوكي، بيقلك الجوامع مش هتقفل)
(والله يا راجل أمي بكت وخربت الدنيا، وحلفت إنى ما أروح الدفانة)
( ياراجل إية شغل الحسوكة بتاع النسوان دا، كل شوية هنغسل ايدينا)
***
الدكتور: قول آه
المريض: ما يقول آه غير النسا
الدكتور: لأ دي آه بتاعت العيا
المريض: آه
(مشهد من فيلم زوجة من باريس / إنتاج 1966)
________________
الهلع لحظة كمية تقف عندها الثواني ويتجمد الزمن، وهنا نكف عن التظاهر ونتخلى عن كوننا “مناسبين” لنوعنا البيولوجي وفق نسق نوعنا الاجتماعي. لحظة لا يكن أمامنا سوى حقيقتنا مهما كانت، وليس أمامنا خيار فى إظهارها أو طمسها.
مشاهد للمواطنين (إناث وذكور) لحظة حدوث زلزال 1992 فى القاهرة، ترسخ في ذهني كجيل عاش هذه الكارثة الإنسانية، رغم وجودي في الجنوب. بشر يركضون فى الشوارع دون هدف سوى النجاة، عيون تزرف الدموع على الفقد وعلى التيه، قلة الحيلة طالت الجميع، بشر لا يفعلون سوى محاولات النجاة بأنفسهم وذويهم.
مشاهد أخرى لقطار الصعيد 2002. الجميع في انتظار أجساد أحباءهم. الجميع يقف على رصيف الفقد.
في حريق محطة مصر 2019، الجميع يحاولون الركض، الجميع يسعون لرصيف يعصمه من الموت. لأننا فى الهلع لا نملك خيار، ليس هناك أي فرص للتبرير أو الجمل المجانية، أو التظاهر بغير ما نحن عليه. ما نحن عليه هو بالضرورة حقيقتنا سواء تسر أو تغم، تناسب أو لا. التظاهر هو أن نكون مناسبين بأقصى قدرة على المناسبة؛ مناسبة كوننا رجال /نساء لسياقات اجتماعية غير إنسانية. فى حين أن السعي المضني لأن نكون مناسبين لا يخالف حقيقة كوننا غير مناسبين بالمرة.
________________________
في أنحاء الكوكب على مدار شهور، عاش الجميع حالة هلع تفشت أسرع وأقوى من كوفيد ١٩. هلع جعل الكل فى حالة ترقب. “هل سأكون أنا المصاب/ة القادم/ة؟” لحظة توحد كونية مفرطة ربما أعادت للكوكب إنسانيته… ربما.
أن ندرك فى لحظة كمية شديدة الوطأة أننا نقف على ذات الأرض، ونستنشق نفس الهواء، سواء المعقم أو المتخم بالفيروسات. ذات الأرض ونحن نفس البشر… بشر دون فروق لونية/عرقية /عمرية/دينية/جندرية. ليس هناك كفار ومؤمنين، ليس هناك سود وبيض، ليس هناك آسيويين وقوقاز. هنا تحديدا ليس هناك رجال ونساء.
لابس كمامة ويمشى (يكشح فى إيديه)، رد السلام على أبو أميرة وهو قاعد على البلكونة ساعة مغربية
وبيتكلم وهو لابس الكمامة
أبو أميرة ما سمعش بيقول إية، فرد عليه بهزار زي عادته
“يا راجل نزل الكمامة مش سامع حاجة، متخافش أنا مش هعديك، أنا قاعد في البلكونة”
ضحكوا الاتنين وشال الراجل الكمامة وقاله
” إية يا راجل، كمان على آخر زمن نخاف من المرض! والله أنت اللي ما سامعين لك حس من يوم الكورونا. إية الدنيا خوفوك وقعدت في البيت؟ حتى عزا الحاج سلامة ولا حد شافك.“
ضحك أبو أميرة “أيوة يخوفوني، وأيوة أخاف. ليه أروح العزا هو فيه عزا أصلا!”
“دي كورونا ، والكورونا مافيهاش مرجلة. كمان دي هنعمل فيها أفلام! الله يخف التقيلة بس”
ضحكا وردد الراجل “يزيح البلا من عنده.”
***
فى معايشة البشرية لجائحة كورونا، كف الجميع عن التظاهر، كفوا عن السعي المضني ليكونوا مناسبين لتصنيفاتهم الجندرية.
كفت الممارسات الاجتماعية عن فرض سطوتها. الممارسات الوقائية هي فقط صاحبة الكلمة العليا. ولأنها – الممارسات الوقائية – نتاج علمي، والعلم سياق إنساني بحت، تنطبق كل قواعدها على الجميع، بل يجب على الجميع الالتزام بها. وأي تباين أو لا مساواة سيُلحقان ضررا بالجميع.
(خليكم في البيت)
(اغسلوا أيديكم بالماء والصابون)
(ارتدوا الكمامة)
(حافظوا على التباعد وعدم الاختلاط)
(صلوا في رحالكم)
بمناسبة الكمامة، الهلع لم يعطل حتى أسواق المنتجات الجندرية عن إنتاج كمامة حريمي وكمامة رجالي، لأن الكمامة إحدي سياقات الممارسة الوقائية، وهذه الممارسة ليس بها حريمي ورجالي، لأن مواصفات صناعتها الكمية هي إنسانية بحتة.
الكمامة منتج علمي ليس له علاقة بالجندر، والوقاية والإجراءات الاحترازية ممارسات إنسانية على الجميع اتباعها، والوباء لا يملك سياق جندري، المرض إنساني، والقواعد تُطَبّق على الجميع. الرجال والنساء يقفون على نفس الأرض، ونسب أو احتمال الإصابة واحدة. ولم تطرح الممارسات الوقائية فى سياقها قواعدا للنساء وأخرى للرجال، أو منتج وقائي نسائي وآخر رجالي. منتج واحد للجميع.
__________________
“خليكم فى البيت”… إجراء وقائي شديد الصرامة، وهو اختبار لهشاشة العديد من الممارسات الاجتماعية شديدة التراكم، والتي رسخت عبر تراكمها هذا لأنثوية البيوت، وفي المقابل ذكورية الشوارع.
جندرية المساحات والأماكن لم تعد لها قيمة فى مقابل إنسانية المرض. ظلت الشوارع خاوية من الجميع، والبيوت قد اتسعت للكل. بعد انقضاء الجائحة، أظن أن الجميع لديه قصة يرويها. أظن أني سأروي قصتي ما بعد إلغاء الحظر وفتح المساحات بشكل جزئي. للمرة الأولى بعد انقضاء ثلاثة أشهر، أقرر المشي في شوارع مدينتي التي أحبها، وبدون كمامة. لا أدري هل الشوارع ثقيلة أم هي أقدامي!
زيارتي لصديقتي المقربة في بيتها، وكم الإجراءات التي اتخذتها وعلينا الالتزام بها قبل الدخول، أشعرتني بهشاشة الود فى مقابل قوة الهلع. صمت الناس في الميكروباص، لا أدري كأنهم لم يصبح لديهم شيء يقولونه، أم أن أفواههم المكممة هي من فضلت الصمت!
المحال إضاءتها مغبرة… الشوارع ضجيجها مكتوم.
في مقابل تجربتي مع الحظر – التي جعلتني ربما أعيد صياغة أفكار كثيرة بشأن حياتي –
تعد تجربتي مع إلغاء الحظر هي الأشد وطأة. وكأن إلغاء الحظر بالنسبة لي كما كتب ميلان كونديرا “كائن لا تحتمل خفته.”
ثلاثة أشهر من الحظر مرت بردا وسلاما، لكني الآن أعيش حالة من التشويش – وربما الغربة – في محاولة للتكيف مع ثقل التعايش.