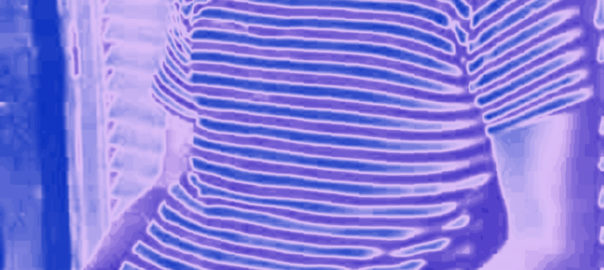منة إكرام
فارس بلا مدينة؟ أم مدينة بلا فرسان؟ عن الرجولية فى سينما خان (PDF)
أنا مولعة بالسينما منذ صغري. وهذا الولع قادني لمشاهدة الكثير والكثير من الأفلام. ولكن تبقى الأفلام المصرية هي أول الأفلام التي شاهدتها كطفلة. أضحك على إسماعيل ياسين، وفمه الواسع وهو يبلع قطعة الحشيش ويقول: “تكونش شوكولاتة؟” فى فيلم ابن حميدو، الذي كانت مشاهدته طقسًا عائليًا مرتبطًا بنهاية الأسبوع.
وهي الأفلام التي شاهدتها مراهقةً، أبدأ مرحلة التمرد والاستكشاف لكل ما حولي. فأتذكر أنني استغليت فرصة خروج والدي من البيت لحضور فرح، وشاهدت الفيلم الذي منعني أبي من مشاهدته “السمان والخريف.” أذكر نادية لطفي وهي ترتدي لانجيري أسود قصير، يظهر مفاتنها، تتلوى على الأرض، وتحاول إغراء محمود مرسى، ليسمح لها بأن تقضي الليلة في منزله.
وهي الأفلام التي، حين قررت أن أعمل بالسينما، عرفت أنها شكلت ذائقتي السينمائية. فأول فيلم كتبته كان اسم البطل “سيف،” على اسم عمرو دياب فى “آيس كريم فى جليم.” وفي الفيلم حضور طاغٍ لمدينة القاهرة التى أعرفها. ولكن هذا الولع بالمدينة من المؤكد أنه كان مربوطًا بصريًا بكل مشهد افتتاحي من أفلام محمد خان.
المدينة وعناصرها في الواقعية الجديدة:
فهذا الولع بالمدينة، بالشوارع، بالتفاصيل هو ما جذبني للقراءة أكثر، والمشاهدة المتعمقة لكل أفلام هذا الجيل، الجيل الذي سمي بجيل “الواقعية الجديدة،” فى السينما المصرية، وكان أغلب وأكثر إنتاجه الناضج، الذى يمثل صلب هذا المشروع، فى الثمانينيات حتى منتصف التسعينات.
فمن ينسى نزهات أحمد زكي في وسط البلد، وجلوسه في كافيتيريا علي بابا، المطلة على التحرير، في فيلم عاطف الطيب، “حب فوق هضبة الهرم.” أو ينسى الساحة الشعبية، التي كان يتدرب فيها أحمد زكي ورفاقه، في فيلم خيري بشارة، “كابوريا،” والتوثيق البصري الأصدق للمنطقة الشعبية. أو أحمد زكى وهو يمارس ملله ووحدته في التنزه في طرقات وسط البلد، في “طائر على الطريق.” كل هذا كون صورة ما عن المدينة، لها مفردات وطعم ومذاق. ما أدركته مع مرور الوقت أن هذه الصورة بها عدة عناصر تبدو ثابتة.
أولًا، أن هذه الصورة فيها أحمد زكي بشكل متكرر. وهو ما سمعت، في أحد الندوات، السيناريست بشير الديك، أحد أعمدة هذه الحركة السينمائية وأهم كتابها، يقول أنه حين كان يكتب شخصية شاب لم يكن مطروحًا سوى أحمد زكي. فهو لم يكن نجمًا متحققًا كنور الشريف، أو محمود عبد العزيز، أو عادل إمام. تعامله مع هذا الجيل الصاعد لم يكن مخاطرة أو تجريبًا، بل هو رمز شبابهم وحلمهم، الذي يكسر القالب التقليدي لشكل الفيلم المصرى، ويخرج به من الاستوديوهات والديكورات إلى الشوارع بشاب مصري، نحيل، أسمر، شعره مجعد، ولا يتوافق بأي حال من الأحوال مع صورة البطل وقتها.
ثانيًا، أن الشارع مكان به الكثير من الظواهر التي غيرت شكله. أضواء وإعلانات نيون تعلو عمارات وسط البلد. شوارع غزتها البوتيكات والسيارات المستوردة، وقهاوي يجلس عليها مهمشون يلعبون الطاولة، أو يدخنون الشيشة، أو يأكلون في مطاعم في الشارع. ولكن الأكيد أن الحضور الأقوى هو للرجل، الشارع ذكوري، حتى وجود النساء فيه مرتبط بوجود رفيقة للبطل، في بعض المشاهد، أو امرأة جميلة أو مغرية، تلفت انتباه البطل، أو تركب سيارة مع كهل عجوز، بعد أن انتهت من التسوق في شارع الشواربي.
ثالثًا، أن هذا البطل هو ما عرفت، فيما بعد، حين درست السينما، أنه نموذج ” البطل المضاد” anti-hero، وهو البطل المحبط، الوحيد، الذي يكتسب الكثير من جاذبيته من غموضه، وعدم اهتمامه بما يفكر فيه المجتمع، وهذا يجذب إليه السيدات، والمتاعب، على حد سواء. لأنه، فى الأغلب، مثل هؤلاء الأبطال، يحاولون أن يعيشوا حياتهم بعيدًا عن التروس الوحشية لماكينة الانفتاح الاقتصادي، وما واكبها من تغيرات اجتماعية، واقتصادية، و سياسية.
رابعًا، أن في هذه الصورة الواضحة للمدينة، تكون السيارات جزءًا من المشهد، سواء أن يكون البطل يمتلك سيارة، تأخذه في رحلات، أو تكون استعارة عما يفتقده في حكايته، أو تكون هي الصورة المعادية للحرية. فسيف يجوب شوارع القاهرة على الموتوسيكل الخاص به، يوزع شرائط الفيديو، ويمارس وحدته المثيرة، التي تلفت عيون الكل. وهي ما يأخذ شمس وكاميرته، ليكون أول من في الحدث، ويصور ما لا يستطيع غيره أن يراه. إذًا فكرة الانتقال داخل المدينة هي هاجس مهم لصناع هذه الأفلام. من سائق الأتوبيس، نور الشريف، أو سائق التاكسى، في “الدنيا على جناح يمامة،” لعاطف الطيب.
فارس وصلاح: وجهان لعملة واحدة؟
رأيت أن هذه الصورة، بالعناصر التي سبق أن ذكرتها، تطرح أسئلة مهمة عن مفهوم الذكورية في أفلام هذا الجيل، والملامح الجندرية، التي تؤصل لها أفلامهم. قررت أن أتناول فيلمين لنفس المخرج ونفس البطل. اخترت فيلمي محمد خان وأحمد زكي، “طائر على الطريق،” إنتاج “المصرية للسينما”، عام 1981، من تأليف بشير الديك، وفيلم “مستر كاراتيه،” إنتاج “السبكي فيلم،” عام 1993، من تأليف رؤوف توفيق.
لقد اخترت هذين الفيلمين لأني أرى أن الأول يمثل بداية فى مشوار خان السينمائي، فأحمد زكي هو أول ” فارس” في ثلاثيةٍ عن “فارس فى مدينة متغيرة،” أكملها خان بعد ذلك فى “الحريف،” عام 1983. وهو فيلم كان من المفترض أن يقوم ببطولته أحمد زكي، ولكن لخلافات لم يكتمل المشروع. ولكن خرج الفيلم ليبدأ بصوت أحمد زكي، بقصيدة كتبتها أمينة جاهين عن التناقضات التي تحدث في الشارع. ويختتم خان هذه الثلاثية بفيلم “فارس المدينة،” عام 1993، بسيناريو شارك في كتابته مع فايز غالي، وبطله محمود حميدة، ليبدأ مرحلة جديدة، في نفس العام، مع أحمد زكي، مرة أخرى، بالفيلم الثاني، الذي اخترته، وهو “مستر كاراتيه.” وهو فيلم حقق نجاحًا جماهيريًا ساحقًا، حتى أن أغاني الفيلم تم إصدارها، في شريط كاسيت، حقق مبيعات عالية، في وقتها.
هذان الفيلمان، يبدو على السطح أنهما مختلفان. ففي الفيلم اﻷول، خان وزكي في بداية مشوارهما الفني. أحمد زكي في الثانية والثلاثين من عمره، وفاز بجائزة أحسن ممثل، من مهرجان القاهرة، وتمت الإشادة بالفيلم نقديًا وفنيًا. أما الفيلم الآخر، خان مخرج فني مخضرم، ينجز أفلامه على هامش السوق التجاري، في الأغلب. يقوم بعمل فيلم جماهيري، مع منتج، الآن حقق نفسه كمدرسة، في صناعة السينما، دائمًا ما تلقى ذم النقاد. والإعلام يحمله مسؤولية التدهور في الأخلاق والذوق العام. ولكنه استطاع مع خان وزكي، البالغ من العمر أربعة وأربعين عامًا، وقتها، إنجاز فيلم حقق إيرادات، ولكنه لم يقابل بنفس الحفاوة من النقاد.
ولكني أرى أن الفيلمين يتشابهان، من حيث ما يطرحانه عن مفهوم البطل، والصورة التي أسس لها هذا الجيل. فأحمد زكي، فى الفيلمين، بطل يحلم بمساحة رحبة، يمارس فيها نفسه بحرية، ولا يريد أية قيود. ولكنه يواجه حقيقة أن البقاء للأقوى. لأنه من أصول بسيطة. ومهما كان احتكاكه بالشارع، فإن الشارع سيغلبه في النهاية. وكذا هو رجل، علاقته بالنساء فيها الازدواجية المعهودة في الرجل الشرقي. والمدينة في الفيلمين حاضرة بقوة، والسيارة جزء من السرد الدرامي للقصة.
فارس على البيجو الأبيض:
يبدأ فيلم ” طائر على الطريق” بفارس، نائم في مملكته الصغيرة، البيجو، السبعة راكب، التي كانت، في أوائل الثمانينات، وفي عز زمن الإنفتاح، قمة الحلم والإنجاز والأمان المادي، لأبناء الطبقة المتوسطة الصغرى. على شاطئٍ بجوار البحر، يصحو من نومه ليغتسل في البحر. ثم يخلع ملابسه ليسبح في البحر. لننتقل إلى لقطة طويلة للبحر والسيارة وفارس والطريق. منذ أول لحظة يؤسس خان لبطله. هو lone wolf، أو ذئب وحيد. طائر يغرد خارج السرب. وحريته هي أهم ما يملكه. لكن فارس ليس منفصلًا عن واقعه. فنراه يأكل في المطاعم الصغيرة الموجودة على الطريق. يعطي بقشيشًا سخيًا للمراهق، الذى ينظف له سيارته، التي يحلم الفتى، يومًا ما، أن يمتلك مثلها، ويكون، مثل فارس، رحالة. وهو، أيضًا، من يقف على الطريق، ليوصل الساندوتشات، لرجل فقد سيارته، وحريته، في حادث سير، فجلس بجوارها على أمل أن يصلحها. فارس يتعاطف مع هذا الرجل، الذي يراه الكل مجنونًا. ولكنه يفهمه ويحترمه. وتكتمل صورة الذكر، أو الرجل الجذاب، بامرأة تركب بجواره، وهو يحاول تجاهلها. ولكن حين يتوقف، للتزود بالبنزين، نراه يواجهها، على الكورنيش، بأنه لا يحب الكذب، أو التعقيدات. وأنه لا شأن له بسيدة متزوجة. وينطلق في طريقه إلى القاهرة، تاركًا إياها، على كورنيش الإسكندرية. ولكن في القاهرة تنتظره عصمت، التى أرى فيها نموذجًا يستحق الوقوف عنده، في أفلام خان، بداية من اختيار اسم قد يكون اسم رجل أو سيدة (عصمت). تلك الفتاة، ذات الشعر المجعد، والأفرول الجينز، والبلوزة المخططة، ووجه خالٍ من مساحيق التجميل، التي يخاطبها فارس، بصيغة الذكر، وينفي عنها أنوثتها، بل حتى فى تعامله الجسدي معها، يتعامل معها كأنها تباع مراهق، يعمل معه في الموقف.
ولكن فارس، وكأي بطل درامى، يجب أن يواجه ما يهز قناعاته وعالمه. وما يفعل ذلك هو “فوزية”، الزوجة الشابة، التي ترتدي تاييرًا أبيضًا بتنورة. وتضع على وجهها المساحيق، التي تزيد من جمالها العادي. حتى قصة شعرها القصير، التى قد يبدو أنها أكثر ما في شكلها ذكورة، فقد كانت موضة فرنسية سائدة في هذا الوقت، وهي مجرد تعبير رأسمالي آخر، عن أنماط الجمال، التي يسوقها الغرب. هذه الزوجة المنسحقة، المطيعة لزوج، أكبر منها في السن، ويعاني من العجز الجنسي، وهذا يجعله، دراميًا، يحتاج إلى رحلات علاجية، من مزرعته، في فايد، إلى القاهرة. وتكون هذه الرحلات، ما يتخذه فارس، ذريعة ليكون بالقرب من فوزية.
ازدواجية فارس، تجاه ماهو أنثوي، واضحة في الفرق في التعامل، بينه وبين عصمت. ففي طريق عودته مع عصمت من فايد، حين تتوقف، وتخلع حذائها في الماء، وتلعب بحرية، يرى هذا على أنه جنون، رغم أنه نفسه يمارسه. ولكنه من امرأة، هو جنون غريب. حتى حين تقبله، لا يندمج مع هذه القبلة، بل يستقبلها بفتور وسرحان. حتى حين تمارس أنوثتها، في إغرائها، بأن تشعل سيجارتها من سيجارته، كأنها قبلة، يراها شيئًا مضحكًا وعاديًا. فى حين أن حضور فوزية في سيارته، كل ما حوله أيروسي. ينظر إليها فى مرآة السيارة. يتتبع حركة عينيها وشفتيها عن كثب. يرى كل ما فيها أنثويًا وجميلًا. حتى مشهد لقائه الجنسي مع فوزية، يكون في حديقة المزرعة، في فايد. هو وهي. آدم وحواء. يلتقطان الثمار من على الشجر، ويحتضنها، ثم يقبلها، ويأخذها في هذه الجنة. ولكننا لا نرى هذا، بل يتم التعامل معه برومانسية التورية، وأصوات العصافير، والموسيقى التصويرية، ذات الإيقاع الرومانسي، وأغنية “أهواك،” لعبد الحليم، تنقلنا لوجودهما، هما الاثنين، في السيارة، وشعرها يطير مع الهواء لأول مرة؛ لأن جاد، زوجها، دائمًا ما يغلق النافذة.
 |
 |
أقوى صورة سينمائية، لمفهومي الرجولة والأنوثة، في هذا الفيلم، هي حين يكون كل من فارس وفوزية في السيارة. وهي تقول له، أنها، الآن، تخاف من الموت، لأنها وجدته. وهو يخبرها، أنه لا يخاف من الموت. فيقرر أن يلعب، لعبة “الديك والفرخة،” مع مقطورة، آتية في مواجهته، وهو يصرخ “هنكسب.” وبالفعل، تغير المقطورة اتجاهها، “كفرخة،” أو كسيدة مغلوبة على أمرها، وهو يفوز، كرجل، “ديك،” مفعم بالذكورة.
هذه الذكورة المفرطة، يقابلها الرجل الغني العجوز، العاجز جنسيًا، العصبي، الذي يريد أن يأخذ فوزية، حتى لو بالاغتصاب، لأن هذا حقه، ويرى أن العالم كله، يجب أن يمضي كما يريد. فهو يقرر، من يعمل، ومن لا يعمل، متى يتم حصد المحاصيل، ومتى يتم نقلها، وكل هذا برعاية نموذج الأم، الذكوري، الذي يداعب ويغذي الـEgo الذكوري، ولا يطلب منه سوى التكاثر، وامتداد النسل. فأم جاد، زوج فوزية، لا ترى فيه عيبًا، بالرغم من أنه تزوج قبل ذلك، ولم ينجب. هي، هذه المرأة، التي تعاملت مع طليقته كـ “ماعون،” غير صالح للحمل والولادة، لكن ابنها كامل.
ولكن الحقيقة أن فارس وجاد، الاثنين، لا يحرران فوزية، لا يعطيانها مساحة، لتكون في مكان أرحب، تحتفي يأنوثتها، بل هما يمارسان ذكورتهما المفرطة، التي تكسر كل شيء. ففي النهاية، عصمت تقرر أن تتزوج. فنراها، في نهاية الفيلم، ترتدى لبس البنات المعتاد، الفستان، شعرها مفرود، ومهندم، ووجها مغطى بالمساحيق، وفى عينيها استجداء، يتجاهله فارس، ويعزم عليها بسيجارة، ترفضها لأن خطيبها لا يحبها أن تدخن. وفوزية، التي أحبت فارس، تحمل، بين أحشائها، ثمار هذا الحب، الذي يجعل جاد يفقد أعصابه، ويُخرج الثور الهائج، الذي يغار على شرفه، ويريد أن يقتلها. وهي تترجى فارس ألا يأتي، قائلة أنها مستعدة أن تموت لتفديه. ولكن فارس، يريد أن يكون فارسًا، على حصانه الأبيض، أو البيجو الأبيض، ينقذها. ولكنه، وهو فى طريقه، يموت فى حادث سيارة. فبعد أن ينحرف عن الطريق، وحين يريد العودة إلى سيارته، أو حريته، تصدمه عربة نقل، وتتركه جثة هامدة على الطريق.
إنني أرى، في نهاية هذا الفيلم، اعترافًا ضمنيًا، أن الذكورية والبطل لا ينتصران، فى النهاية. ولكني أعرف جيدًا، أن ما يطرحه الفيلم، هو عكس ذلك تمامًا. ففارس هو ضحية مجتمع عجوز، مهزوم، ومدن تتضمحل. ولكن هذا التضاد، قد يكون، كما يقولون فى قواعد اللغة العربية، “تضاد يقوي المعنى ويوضحه.”
صلاح بين العنف والكاراتيه:
أرى أن مستر كاراتيه، هو امتداد طبيعي لمفهوم الذكورة في ” طائر على الطريق،” بالرغم من كل الاختلافات السالف ذكرها. ففيلم مستر كاراتيه يبدأ فى حقول قرية. وهناك، يحمل أحدهم، على حمار، تليفزيون وآريال. فنرى الكل مترقبًا ظهور ابن قريتهم الشاب، “صلاح،” فى برنامج أماني وأغاني. وهذا ما أحبه في سينما خان. فبدون أية مباشرة، أو خروج عن نمطه السردي، يوثق عالم القاهرة، الذى أتى للقرية، حاملًا كاميراته، ومذيعه المشهور، وقتها، جمال الشاعر، ليتحدث مع الشباب عن أحلامهم المهدورة. ونعرف أن صلاح لديه مؤهل دراسي، وينتظر التعيين منذ 8 سنوات. هو إذًا شاب فى الثلاثين. أي أن زكي أكبر بحوالي خمسة عشر عامًا من بطل خان، الذى يغني ” توبة،” لعبد الحليم حافظ، بمزيج من الخجل والفرحة، التي يقابلها الموجودون بالسخرية، ولكنه لا يبالى. فقلبه الطيب يحرج، لكن لا يجرح.
 |
 |
الكابتن وصلاح فى ظل بروس لى، وفى نور الراقصة
ولكن صلاح يستقبل والده، العائد جثة من القاهرة، ليرث مكان أبيه فى الجراج. وهنا يبدأ التأصيل لشكل ذكوري جديد، خلقته الظروف الاقتصادية. الأب الغائب في المدينة الكبيرة، أو في الخليج، أو في ليبيا، أو في أوروبا، يعمل ليرسل المال، ليعيل أسرته، التى ترعاها الأم. وحين تستهلك الحياة الأب، يأخذ الأخ الكبير الدور. ليبقى حضور الرجل غائبًا، إلا من المال. ليفقد إدراك أسرته الإنساني له.
من أول لحظة له في المدينة، في الجراج، يرى صلاح أن السيارات هي مهمته، وشغله الشاغل. ينظفها، ويحرسها، ويعطي “البرستيج” لأصحابها بأن يلبي طلباتهم، قبل أن يطلبوها. هذا النموذج المدجن من الرجل الريفي، الذي لا يعرف قواعد العيش، فى مدينة مثل القاهرة. فتتم سرقة الجراج، فورًا، وتهان كرامته، ويكون ضعيفًا، ولذا يريد أن يكون أشرس، ليواجه هذا الجنون.
يهرب من هذا الضعف، أولا/ إلى أفلام الكاراتيه، (بروس لي، وجاكى شان)، وكيف أنهم، في هذه الأفلام، مثله، كانوا underdogs، أي فى الموقف الأضعف. ولكنهم طوروا من قدراتهم، واستطاعوا أن ينجحوا، ويكونوا أبطالًا، ويغلبوا الشر. وربما كان هذا ما يريد السبكي إنتاجه. قصة صعود تقليدية. فيها “العيل” يصبح “راجل.” ليتطور النموذج. ليكون “الأسطورة،” أو “قلب الأسد،” محمد رمضان، الذي يشبه زكي، إلى حد كبير، وهو، الآن، البطل الشعبى الأول في مصر. ولكن خان لم يخن فكرة الـبطل المضاد anti-hero. فهنا، صلاح يواجهه المجتمع الذي يتغير. ولكن خان يقوم بمساومة، ليندمج في التركيبة السبكية. فهو، لا ينتصر للنهاية، ولا ينهزم للنهاية. وهو ما سنتحدث عنه، لاحقا.
 |
 |
صلاح عند وصوله المدينة، وصلاح كمستر كاراتيه
ولكن ما أراه مهمًا، فى تناولنا الذكورة بمفهومها الجندري في سينما خان، أن صلاح يجد الكابتن النقاش، ذو الجسد القوي، الذي يعرف أحسن أفلام الكاراتيه، ويعرضها في القهوة، ويتجمع الكثير من الرجال فيها؛ يشربون الشاي، ويلوكون السندوتشات، ويشاهدون هذه الأفلام، لتعوضهم عن انسحاق رجولتهم، في البحث اليومي عن لقمة العيش، والحياة الكريمة. ولكن صلاح لا يكتفي بالأفلام. فهو مُهَاجم، ومطلوب منه الدفاع عن نفسه. فيأخذه الكابتن، ليتعلم الكاراتيه، لنراه في لحظة، بعد أن كان يمسح شقة أحد أصحاب السيارات، وينظفها له، وهو يعطيه المال والملابس، يرتدي الجينز المستورد (المشحوت)، ويقف على الحائط، مرتديًا نظارة شمس، ويغني، من كلمات سيد حجاب، وألحان كمال الطويل، “أيوه يا دنيا يا بنت الايه،” التي يعد العالم، فيها، أنه سيرد الصاع صاعين، وأنه، “هيقص، يقص، وهبقى البوس، وأرقص، كده، على واحدة ونص.” فهذه الذكورة المتحصنة بمهارات جديدة، مكتسبة، فى الكاراتيه، واحتكاك بشوارع المدينة، ممزوجة بما تبقى من شهامته الريفية، تجعله بطلًا محببًا، تقع فى غرامه، نادية، الفتاة التى تعمل فى محل الفيديو. فهو لا ينظر لها بشهوة، كزميلها في المحل، ويتضايق أنها تعمل “شيفتات” متأخرة فى المحل، ويوصلها إلى محطة الأوتوبيس، ويعزمها على ذرة. إذًا، هو رجل، بالمفهوم التقليدي للرجولة. حتى أنها حين تأتي لتعطي أوراقها لأحد ساكني العمارة، الذي ينظف هو له الشقة، يضربه، وينفعل عليها، لأنه رجل شرقي، ولا يقبل أن تعرض عليه نفسها، بهذه السهولة.
ولكن خان يرينا أن أبطاله ينسحقون. فزكي، بعد أن أصبح شرسًا، وعنيفًا، وقادرًا على حماية نفسه من أقرانه، مازال لا يستطيع أن يكسب الأغنى. فطفل مراهق، أراد أن يسرق سيارة والده، ويحاول هو إيقافه، يكسر رجله، ويتركه عاجزًا، أعرجًا، لا يليق به لقب مستر كاراتيه. حتى حين حاول أن يحافظ على بقية من رجولته، وألا يأخذ عوضًا لإصابته. يكتشف أن رئيسه أخذ الفلوس، وأعطاها لأهله، في البلد، الذين دخل بيتهم التليفزيون. فيقرر صلاح أن يترك هذا المكان المشوب بالهزائم، ويبدأ في مكان جديد.
ولكن البداية الجديدة تبدو سهلة وبسيطة، حتى يدرك وجود أبو الوفا بيه، الذي يغدق عليه بالمنح، ويثني على أدائه، ولكنه لا يراه ولا يعرف من هو، أو ماذا يفعل. وكيف يعرف عنه، ذلك الرجل الذي اختار خان أن يكون رمزه البصري عمارة شاهقة الطول، بالكثير من الشبابيك، تطل على ساحة الجراج، الذى يحرسه زكي. ولكن هذا لا يمنع من بضع انتصارات صغيرة. أن يصرف فتى وفتاة، كانا يقبلان بعضهما فى الجراج. أن يعيد علاقة حبه بنادية، ويخطبها. وأن يكتشف أن هناك نقطة استلام مخدرات في جراجه. ولكن هذه المدينة، وهذا الواقع يرفضان أن يثبتا وأن يستقرا، فالكابتن، الذى علمه الكاراتيه، استخدم رجولته، وجسمه الكبير، في أن يحرس السكارى، ويكون بودى جارد في كباريه. صدمة صلاح تكون كبيرة، لأنها تضرب مفهوم الرجولة فى مقتل عنده. وهنا يسكر ويغني ثاني أغاني الفيلم، “طبل ترقصها،” التي فيها، حجاب، والطويل، وخان، يؤكدون أن لغة العصر تفرض على الشخص أن يكون سلسًا، ويقدم تنازلات، حتى يحافظ على ما تبقى من رجولته. وينتهي المشهد بأن الكابتن يدفع ثمن هذه المواءمة، ويلبس جريمة شغف بين الأغنياء. ويستفيق صلاح، وهو يغني أغنية حزينة، عن البلد، وكيف أنها تضغط على أبنائها، فى خلطة تجمع ما بين فلكلور النحيب الصعيدي، في طريقة سرد تشبه الأفلام الهندية التجارية، لتولد الخلطة السبكية الناجحة.
فى النهاية، لأن صلاح لا يجب أن يهزم، كل هذه الهزائم، يقرر أن يبلغ البوليس عن شحنة المخدرات. ولكنه يُضرب، ضربًا مبرحًا من رجال أبو الوفا. ولكنه يقرر اقتحام المبنى، والانتقام لرجولته. فيأتي تتابع، وهو يضرب مختلف رجال أبو الوفا. مع تقطيعات سريعة، لبروس لي فى أفلامه الشهيرة، حتى يصل لأبو الوفا، وينجح فى استرداد جزء من كرامته المهدورة. ولكنه يعود للبلد أعرجًا، ومعه فتاة هزمتها المدينة، تجرى فى الحقول، لينتهي الفيلم.
خاتمة لابد منها:
هذه القراءة، هي قراءة يدفعها شغفي بأفلام محمد خان، وحبى الشديد لأحمد زكي، كبطل سينما. هى قراءة، أحاول أن أفهم فيها، لم أقدر هذه الأفلام، وأحبها، وأشاهدها، مرة تلو الأخرى؟ لأني أراها صادقة، نابعة من خبرة وشغف حقيقيين لخان، كمخرج له وجهة نظر، ويحب أبطاله، ومدينته، ولديه إدراك، قادر على التواؤم مع الظرف الإنتاجي، واللحظة التى يعيشها المجتمع. ولكن، أيضًا، هي محاولة لرصد أن القاهرة في السينما ذكورية. لأن الواقع ذكوري. وكذلك، لأن أغلب صناعها من الرجال. وهنا، أجد نفسي أفكر فى هذه الذكورية السينمائية، وماذا تعنيه لي، كمشاهدة، كمحبة لهذه السينما.
ولكن مستوى الإدراك الأهم يأتي كامرأة، تحاول صناعة الأفلام، ورواية حواديت، توثق لهذه المدينة الطاحنة، وكيف غيرت أنوثتي، وممارستها. وكيف جعلتني أرى الذكوري، كما هو عليه، السائد والمسيطر، فى كثير من الأحيان، يخنق حرية إبداعي، وحركتي، وانخراطي فى المدينة. ولكن كل هذه القيود لا تضعني فى حالة كره. ولا تجعلني أرى الذكورة مرادفًا للقبح. بل تزيدني رغبة في أن أمارس حياتي، كما أريدها، وأحتك بالذكورية، فى ديالكتيك شخصي. فربما، في يوم من الأيام، أصنع فيلمًا، يقرأ فيه غيري، بعد سنوات كثيرة، عن الجانب الأنثوي للمدينة.
فتاة نادى الفيديو