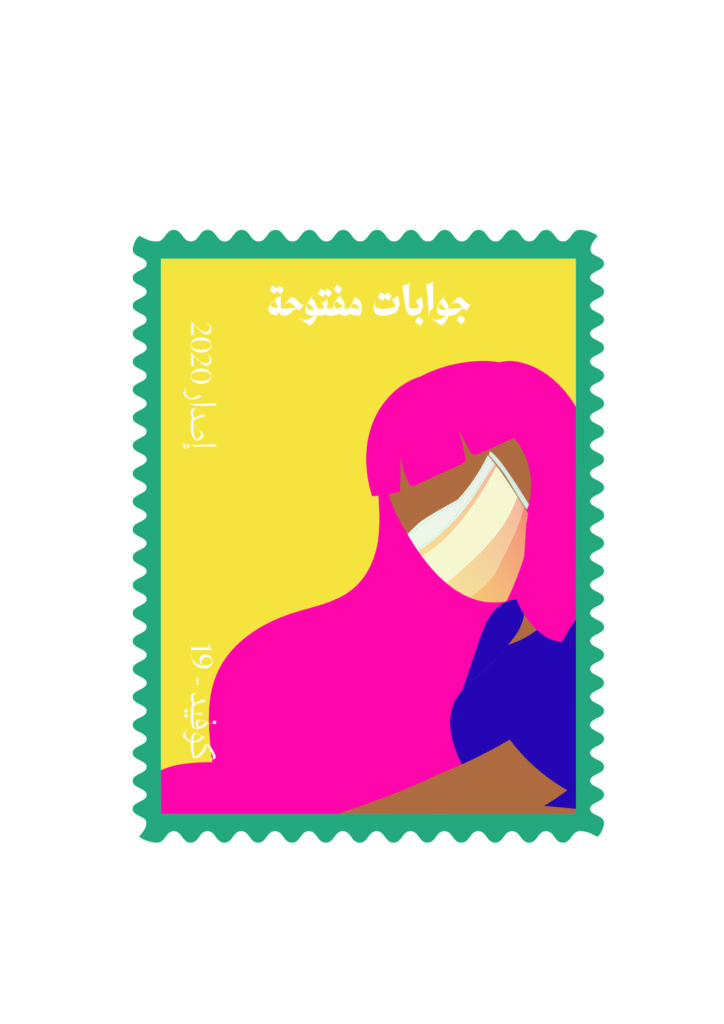بعدما انتهى الحظر شعرت بالأسى، أسى لا يعرف طعمه الكثيرون. كثيرون سعداء بعودة الحياة وصخبها من جديد. بعضهم سيذهب إلى المقاهي أو يسافر أو يشتري ملابس أو غيرها من متع الحياة التي اعتادوها. ورغم أن الخطر من الإصابة بالفيروس ما زال موجودًا، إلا أني أيضًا شعرت بالأسى، لأني في الحجر الصحي كنت أشعر بشكل من أشكال التضامن، حتى لو كان صوريا. كلنا في مركب واحد، وكلنا نعاني من نفس الأزمة رغم اختلاف التفاصيل. أما بعد الآن، فقد انتهى كل شيء، وعادت كل ريما لعادتها القديمة، في حين لا أجد أنا وكثيرات مثلي ما نفعله، إلا الاستمرار بحجرنا الأبدي الذي لن ينتهي إلا بالصدامات والمواجهة القاسية.
أنا الفتاة الصعيدية، التي تعيش في مستنقع الذكورية بأبشع صورها، كنت أظن منذ سنوات أن تلك هي أزمة فردية ومشكلتي وحدي ولا داعي لأن أتحدث عنها. بعدها فهمت وأدركت أن السلطة الأبوية والمجتمع الذكوري هم السبب في كل ما يحدث لي ولغيري من الفتيات، وأنه لا بد لنا من أن نتحدث ونثور ونكسر حاجز الصمت، ولو بشكل صوري. ولا أنكر سخطي على كل شيء وعلى ما أعيشه كل يوم، بسبب ذكورية الحياة والمجتمع والأهل والأصدقاء، بدءاً من رغبتي في أحلام لن تتحقق إلا بدفع ثمن باهظ.
استمر الفيروس في الانتشار واستمرت حياتي في روتينها المعتاد. كنت أخرج أيامًا قليلة وللضرورة فقط، وهذا يُشعرني بالأمان لأني بعيدة عن الخطر. جلست أراقب العالم من نافذة هاتفي الصغيرة أو من وراء الشاشات بشكل عام. شاهدت حفلا لفرقة كايروكي، ومرة حفلا للعسيلي في “شم النسيم”، وبعدهم بفترة شاهدت حفلا لإليسا يُبث أونلاين أيضًا. كنت مذهولة من كل ما يحدث ويجري في العالم… كل هؤلاء يهتمون بضجر الموجودين في منازلهم! أعرف تمامًا أن تلك الحفلات موجهة لفئة معينة، تحديدًا لمن كانوا يحضرونها بالأساس – وأنا لست من تلك الفئة إطلاقًا – الفئة التي ليست بالغنية فلديها رفاهية الذهاب لمثل هذه الحفلات أو غيرها، أو لا تعيش في بيئة نسوية تسمح لها بالذهاب لتلك الحفلات أصلاً. لا أُنكر أني في الأعماق، كنت أشعر ببعض الشماتة في آخرين، أقول لندعهم يشعروا بنا ونتركهم يتأملون كيف تعيش الكثير من الفتيات حبيساتٍ في بيوتهن، في مُدن مغلقة ومع أُسر أو أزواج لا يتهاونون في أي شيء يمكنه أن يُهدد “شرف العائلة”.
مرت ثلاثة أشهر منذ أن حزمت حقائبي وتركت سكني المشترك الذي قضيت فيه ليال طويلة، للعودة إلى منزلي، في مدينتي الصغيرة النامية. كانت تلك المرة الأولى التي أستقل فيها بعيدًا عن أهلي. حجزت تذكرة السفر وودعت كل شيء بتأنٍ، واستعدت ذاكرتي التي أعادتني ستة أشهر للوراء، منذ نزلت للمرة الأولى في حياتي إلى القاهرة، أنا الفتاة الجنوبية/الصعيدية، التي سافرت القاهرة لتدرس في إحدى المنح بالجامعة الأمريكية. كان سبب عودتي هو أن مشروع تخرجي لن يُناقش بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، ولم يكن يفصلني عن موعد المناقشة النهائي سوى أسبوعين. كُنت قد قررت العودة إلى المنزل بعد مناقشة المشروع وانتهاء كل شيء كما وعدت أمي، لكن كان لكورونا رأي آخر، إذ وجدت أن كل الأحداث تتسارع وتيرتها، وخفت من أن يُفرَض حظر تجوال أو ما شابه، لذا قررت العودة قبل موعدي المحدد بأسبوعين. وقلت لا بأس، من الممكن أن تكون هذه فرصة أخرى للعودة إلى القاهرة وعيش الحياة من جديد. عدت إلى منزلي بعد ساعات طويلة من السفر، وبدأت أتأمل كل شيء، وأنظر إليه بعين مختلفة، أكثر سخطًا وتمردًا مما مضى. كان سفري للقاهرة أحد أحلام حياتي المؤجلة، وبحثى عن فرصة للعيش ورؤية الحياة بشكلها المختلف. خُضت حربًا ضروسًا مع الدنيا كلها لكي أسافر وألتحق بهذه المنحة. كانت الأشهر الستة التي قضيتها في القاهرة، والحروب التي خضتها مع نفسي أولًا ثم أهلي ثم العالم، بمثابة نقطة تحول في حياتي، وكان من المفترض أن أعود وأعيد التفكير في كل شيء، إلى أن تأتي فرصة أخرى أو أرى ما يمكنني فعله في حياتي لأخطو نحو الأمام. لكن كورونا أبى أن يكون لي خيار، وقرر بدلًا عني، ولم يكن هذا القرار يزعجني أو يضايقني، بل منحنى فرصة للسفر في وقت آخر. كانت عودتي ومكوثي في منزلنا رغبة من رغباتي، لم أكن قد استوعبت رتم الحياة السريع وكل ما مررت به دفعة واحدة بعد. أردت أن أستريح وأتأمل وأكتب وأحكي عن كل ما عشته، لذلك كان بقائي الدائم في المنزل أحد قرارتي التي صبت في مصلحتي ولم أضجر منها إلى الآن. بدأت في فعل كل الأشياء المؤجلة، مهام عملي المتراكمة، وكتبي التي تركتها لحين اتفرغ لها، وقائمة أفلامي، ومجموعة الأشياء التي اعتدت فعلها كي أطور من ذاتي.
كانت أيامي الأولى بمثابة راحة وهدوء. ولا أنكر أنه تخللها كثير من الضيق بسبب كل ما رأيته من فقدان للحرية وشعور بالتقييد – حتى في أبسط الأشياء – بدءًا من الملابس وصوت ضحكتي ونظري بشعري من شرفة المنزل. كنت أعيش حياتي داخل حاسوبي المحمول وكتبي وأفلامي. أخذت أقرأ كثيرًا كثيرًا عن النسوية وحقوق المرأة، وعن الحياة غير العادلة بشكل مطلق. وخلال انغماسي في حياتي الذاتية، كنت أراقب صفحات صديقاتي على مواقع التواصل الاجتماعي. كنت أرى كل منهن تعبر عن خوفها بطريقتها، وتضجر وتتحدث عن مشاعرها الشخصية. إحداهن تقول “سننجو”، وأخريات يتبادلن روتينهن اليومي في الحجر الصحي، وأخريات يعبرن عن ذعرهن مما يحدث، وعدم قدرتهن على فعل أي شيء. كنت لا مبالية، فقط أنظر لهم بسخرية، وأقول كل هؤلاء – سواء كُن نساءًا أو رجالًا – لديهن حرية وأشياء يفتقدنها في حياتهن. أما أنا ومثيلاتي – وأنا مؤمنة بأننا كثيرات – للأسف لا يفرق كثيرًا روتيننا في الحجر الصحي عن الأيام العادية شيئًا، لأن إرادتنا وحريتنا مسلوبة من دون أن يأتي كورونا أصلًا.
كانت المهام المتراكمة لدي كثيرة. ستة أشهر من الغياب ليست بالوقت القليل. بدأت أكتب كل ما أجّلته، فأنا أعمل كصحفية حرة. وعدت لتعلم دروس اللغة الإنجليزية التي بدأتها منذ شهور. كنت أشاهد أفلامًا ومسلسلات وأفكر متى ستنعم لي الدنيا بزيارة تلك البلدان والأماكن. لكن كان تفكيري بطريقة مختلفة هذه المرة، فأفكر ماذا يمكنني أن أفعل حتى أزور تلك البلاد؟ ويفصلني الواقع بصوت أمي التي تحدثني عن أمنياتها برؤية أطفالي وسعادتي الأبدية في بيت زوجي. يصدمني ذلك الصوت المتكرر، الذي لم يمل من ترديد تلك الأمنيات التي تصفعني دائمًا لأرض الواقع، وتسحبني من أحلامي اليقظة لتردني إلى العالم القاسي، الذي يقول لن تحققي أي شيء إلا وأنت مع زوجك، ولا سبيل للخروج من هذا المنزل إلا بالزواج، أي من سجن إلى سجن آخر.
كنت أرى أصدقاءً ينشرون صورهم وذكرياتهم التي يفتقدونها. بعضهم يفتقد صوت الطائرة، وإحداهن تفتقد الذهاب إلى البارات، وأنا هنا ما زلت أحلم باليوم الذي أنال فيه كافة حقوقي وأعيش الحياة برغبتي واختياراتي. أتابعهم بأسى وأغبطهم، وأفكر في حياتي التي لم يغيرها الحجر الصحي ولا كورونا، ولن ينتهي بؤسها إلا بانتهاء النظام الأبوي، وليس بانتهاء وباء يمكنه أن يفتك بالجميع، لكنه لن يقلل من طغيانهم أو تجبرهم على النساء.
رأيت فرصًا كثيرة واستثنائية تُقدَم لأول مرة بشكل افتراضي، لكن الغريب أنني لم أنجذب لتلك الأشياء رغم تقديري وحبي الكبير لهذه الفرص، إذ أنني عشت طوال عمري معتمدة على الورش والتدريبات الافتراضية، فما الذي تغير! مللت من الحياة التقليدية وروتيني العادي الذي يتعامل معه الأغلبية وكأنها فرصة ذهبية لقراءة كتبهم المؤجلة وإنجاز الكثير من المهام التي ستطورهم. وبرغبة صادقة أتمنى لو أشارك هؤلاء الجموع وأنضم إلى صفوفهم في الحديث عن إنجازاتي، وعدد الكتب التي قرأتها. لكن الحقيقة أن هذه هي حياتي العادية، وتلك الإنجازات هي جزء من روتين حياتي المعتاد ليس إلا.
مرت الأيام وتغير روتيني بعض الشيء، لكنه تغير للأسوأ. كنت آخذ بعض الراحة، لكن حتى الراحة تلك لم تكن تخلو من ألم، فكنت أنام لأستيقظ على شجار كبير بين أخي وأمي – في أغلب الوقت عني – كون أخي لا يتقبل أن أخته أفضل منه، فيطيح بها بكل ما لديه من سلطة ذكورية يمدها له المجتمع بأكمله. كثيرًا ما بكيت وضجرت ورغبت في انتهاء كل هذا المُر، لكني أعرف أن كورونا ليس هو السبب في ظهور هذا كله ولن يتسبب في اختفائه، ولهذا أشعر بالأسى أكثر فأكثر على نفسي.
أصبحت نظرتي للحياة أكثر عمقًا ونضجًا واتساعًا. أصبحت أقرأ كثيرًا وأرغب في أن أغير الكثير في حياتي، فأعمل وأقرأ وأكتب وأتعلم، وأنتظر الغد بعين نصف متفائلة لأرى ما الذي يمكن أن تخبئه لي الأيام. لم يشغلني كورونا كثيرًا في العملية بأسرها، ولم يشغلني كذلك ما أحاط به من إجراءات، كنت فقط أتابع الأخبار، ولا أنكر أنني أحيانًا كنت أخاف من تفشي الوباء الذي لا نعلم إلى أين سيصل، أو إلى أي مدى ستكون أضراره. لكن تفاصيل الحجر المنزلي والصمت والعزلة هي التي وحدت الأفكار والإحساس بعمق الأذى والضرر الواقع علينا كنساء من هذا المجتمع البطريركي القاسي.