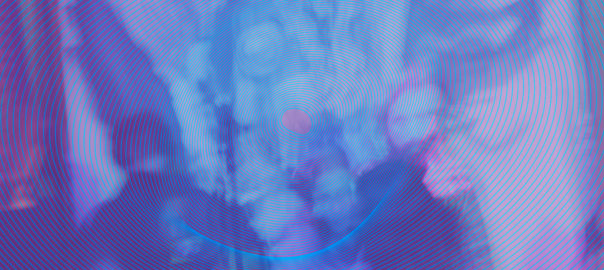كتابة: سارة سالم
ترجمة: ريبيكا صعب سعادة
العقلاني في مقابل العاطفي (PDF)
بالعودة إلى مشاركتي السابقة، كنت قد كتبت عن الهشاشة وعن إعتبار بعض المشاعر “خاطئة” بسبب ميلنا إلى الإمعان في التحليل والقسوة على النفس عندما تنتابنا هذه المشاعر. تأتي هذه المشاركة للبناء على تلك، مع التركيز أكثر في التناقض المفترض منذ زمن بعيد بين الفكر والإحساس. لطالما تمّ تأطير هذه الثنائية ضمن التعارض بين المنطق والعاطفة، وممّا لا شكّ فيه أنّ هذا الإطار لا يخلو من تأثير الفكر العنصري والذكوري. وفقاً لهذا الإطار تمتاز النساء بالإحساس والرجال بالفكر، النساء عاطفيات وتتأثّر قراراتهنّ بعواطفهنّ، في حين أنّ الرجال منطقيون وقادرون على التحكّم بمشاعرهم. جاهدت النسويات لسنوات طوال من أجل زعزعة هذه الثنائية، إمّا من خلال التشديد عاطفية الرجال وعقلانية النساء، وإمّا من خلال المحاججة بعدم جواز الفصل بين المنطق والشعور.
لطالما تبنّيت هذا الرأي. منذ نعومة أظافري وأنا أرى أنّ كل إنسان عاطفي ومنطقي في آن واحد، وأنّ الفصل بين ما هو “عاطفي” وما هو “منطقي” صعب عند إتخاذ أي قرار. أنا مقتنعة أن للناس شخصيات، ووفقاً لشخصية الفرد تختلف درجة العقلانية والعاطفية، لكنّني غير مقتنعة أنّ ذلك مرتبط بهوية النوع الخاص به/ا. وفي حين أرى أنّ الجهود النسوية المبذولة في هذا الإطار فائقة الأهمية، إلا أنّها، إلى حدّ ما، لم تنجح في المحاججة ضد إعتبار العاطفية كحالة سلبية أو صفة سلبية. بمعنى آخر، لم نقم بما يكفي من المحاججة بأن العاطفية صفة جيدة، لا بل أساسية، وذلك بهدف المحاججة أنّ هوية النساء لا تقتصر على العاطفية وحسب، بل تشمل أيضاً حساً منطقياً كما الرجال.
ومع إستمرار العيش في هذه الهالة السلبية المحيطة بالعاطفية، أصبحت كلما وجدت نفسي في وضع معيّن يستحثّ فيّ مشاعر قوية أو قاسية، يأتي رد فعلي التلقائي عبر عقلنة الموقف، ومنطقته، والتفكير ملياً، والتحليل، والتفهّم. تجدر هنا الإشارة إلى أنّني لا أقصد القول أنّ هذه المواقف عقلانية بحتة أو أنّها غير مرتبطة بالعاطفة، غير أنّها تُعتبر عادة نوعاً من تفادي العواطف. بالتالي وجدتني أهرب من مشاعري عبر سعيي لفهمها بشكل “عقلاني”، كما لو أنّني أحاول أن أفهم “لماذا” ينتابني شعورٌ معيّن كي يهدأ الشعور نفسه ويغيب، وهذا طبعاً من المحال. إذ إنّ المنطق، أو ترجمة شيء بشكلٍ قابل للفهم، لا تستبدل حاجة الجسد والنفس والقلب لشعور معيّن. لا يمكن لعملية ذهنية معينة أن تستبدل الأخرى، لا بدّ لكلّ منهما أن تكتمل.
في عصرنا هذا، أظن أن عدداً كبيراً من النساء يعيش في بيئة تقول لهنّ أنّه لا بد لهنّ من الفهم الذاتي، عبر الإستشارة النفسية، وجهود التحسين الذاتي، وسعي الأصدقاء للإفصاح عن الحقيقة المرّة، وما سوى ذلك من آليات فهم الأسباب الكامنة وراء القرارات التي نتخذها. لا أرى في ذلك أيّ سوء سوى أنّها مبنية على إفتراض أنّ كل شيء قابل للتحليل المنطقي. وفقاً لهذا المنطق، متى عُرف السبب بطُلَ الفعل نفسه. غير أنّ فهم المشاعر لا يساوي الإحساس بها، أن نفهم لماذا نشعر بطريقة معيّنة لا ينفي حاجتنا لعيش الإحساس نفسه. كما أنّ معرفة ما يشعرنا بالسعادة لا يوازي الشعور بالسعادة. ومن هنا، يسهل علينا أن نفهم خطورة وعدم جدوى محاولاتنا إستبدال مشاعرنا بفهمنا لمسبباتها.
يذكرني هذا التسلسل الفكري بالدين بعض الشيء، يشدد الفكر الإسلامي على نقطة لطالما استرعت إهتمامي، ألا وهي عجز الإنسان عن فهم بعض الأشياء. يجب ألا نركز كبشر على فهم كل شيء، وحتماً ليس على فهم الله أو أسباب كل ما يحصل حولنا. بل يجب علينا التركيز في كيفية التواصل مع الله ومع بعضنا البعض، وركيزة هذا التواصل تكمن في نهاية المطاف في تقبّلنا لبعض الأساسيات، كعدم حاجتنا لمعرفة كل شيء، وضرورة تقبّل إستحالة معرفة الأسباب في بعض الأحيان. في عصر الحداثة الذي نعيش فيه، وفي ظل هيمنة المعرفة على تعريف هوية الإنسان، يصعب علينا القبول بعدم قدرتنا على فهم شيء ما. نحيى في حالة من توقّع الفهم، لا بل” المطالبة” بفهم كل شيء. مع العلم أنّ قبول إمكانية “عدم القدرة” على معرفة ما يجري لنا أو فهمه لا يعني بالضرورة أنّه لا يجوز لنا التفكير في الأسباب، بل أن يكون تركيزنا نحو التقبل بدلاً من المقاومة. ففي غياب الفهم لا يبقى أمامنا سوى القبول – وهكذا نسمح لأنفسنا بالشعور. إنّ تقبل ما حصل يفتح أمامنا أبواب الشعور بالألم وخيبة الأمل المرافقين له. في حين أن السعي المستميت للفهم يرجئ لحظة الوجع، هو التعلّق بأمل أنّنا لو عرفنا السبب بطُل الألم، أو حتى أنّنا لو عرفنا السبب إستطعنا تغيير الواقع.
يمثّل مسار التقبل، وبالتالي الشعور بالألم، هو الأفضل من حيث القدرة على مساعدتنا للفهم، إذ يحسّن من قدرتنا نحن على الفهم. بهذه الطريقة نكف عن الهرب من شيء ما ونتمكّن من تحليل ما جرى لأنّنا بالفعل عبرنا الأحاسيس الواجب الشعور بها، وبالتالي بتنا قادرين على العمل من أجل فهم الأسباب الموجبة لهذا الشعور.
أنا شخص أكاديمي، لطالما سعيت لفهم كل شيء، كما أنّني بشكل عام لا أرتاح لما لا أتحكّم به، لذلك وجدت في الأشهر الماضية صعوبة بالغة في تقبّل أشياء معينة والتعامل مع المشاعر المرافقة له. سواء كان ذلك تقبّلاً لقرارات اتخذتها أو تقبّل أنّ بعض سنوات هذه الحياة أصعب من سواها، أو تقبّل أنّ كل شيء سيكون على ما يرام في نهاية المطاف. قاومت بشكل مستمر من خلال الإصرار على تحليل مشاعري. ثمّ لا يمكن أن ننسى الجانب الجندري، كنت أخشى الإستسلام لمشاعر معينة لأنّني مدركة تماماً تنميط النساء بأنّهنّ أكثر قابلية للـ”مبالغة” في الإنغماس في المشاعر. فحاولت وضع حدود لمشاعر معينة، أو أقلّه عدم السماح لمشاعري بالطغيان على فهمي. لعلّ ذلك أصل المشكلة، ماذا لو كانت مشاعري هي “الأَوْلى” بتحديد فهمي لبعض المواقف. صحيح أنّ المشاعر معرّضة أكثر للتأثّر برواسب عدم الأمان لدينا – وهذا ما ينبغي علينا تهذيبه وتحسينه – إلا أنّ مشاعرنا أيضاّ جزء لا يتجزأ من ذواتنا. بالعودة إلى الأشهر الماضية، أرى أنّ مشاعري غالباً ما أشارت إلى ما لم يكن ذهني جاهزاً لتقبّله، أو لم يكن يريد تقبّله.
ومما سبق إليكنّ خلاصتي النسوية: من الواضح أن الثنائية القطبية بين الفكر والإحساس ليست متينة، كما من الواضح أنّ هذا المفهوم متأثّر بالعنصرة والجندرة، لكن، مما لا شك فيه أنّنا ترعرعنا في بيئة تمجد الفكر وتحتقر الإحساس. لكن يبقى الإحساس هو القادر على إعادة ما فقدناه مع مر السنين، ولا يمكننا الإستمرار في النمو الذاتي من دونه. الإحساس يمكّننا من “الفهم” بالمعنى الأوسع للكلمة. فلنسمح لأنفسنا بالشعور إذاً، في حلوه ومرّه.