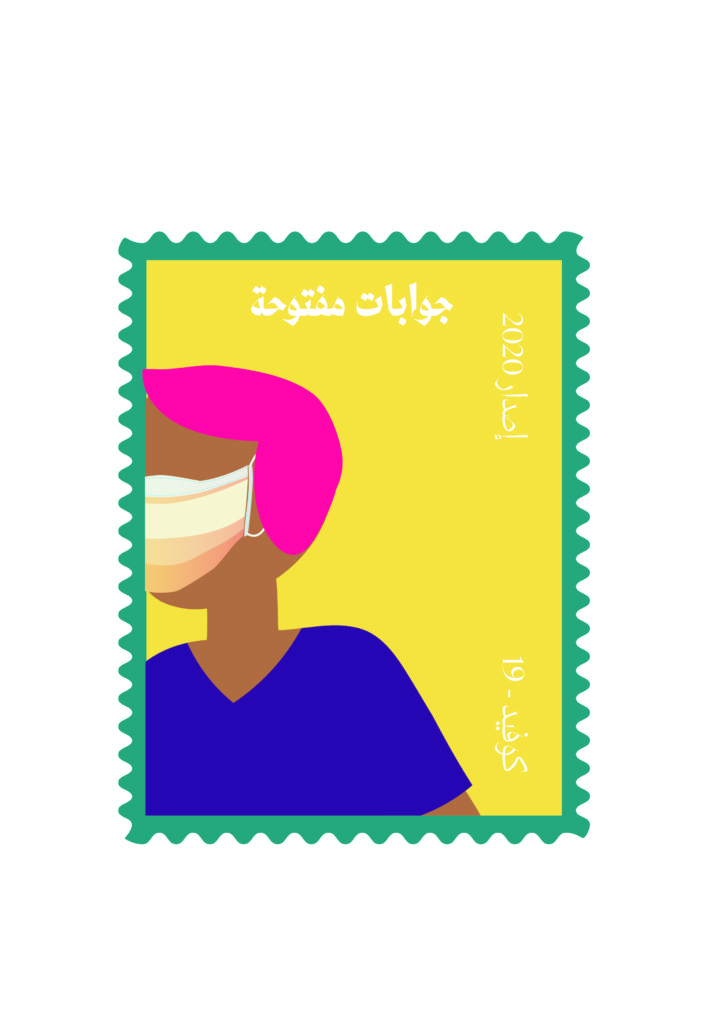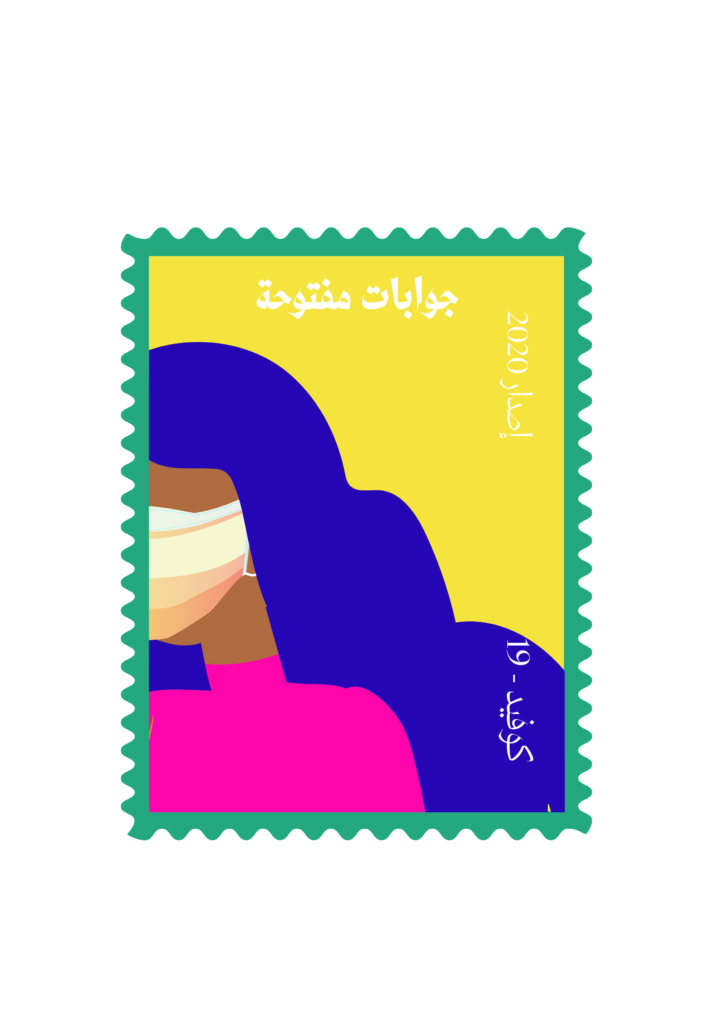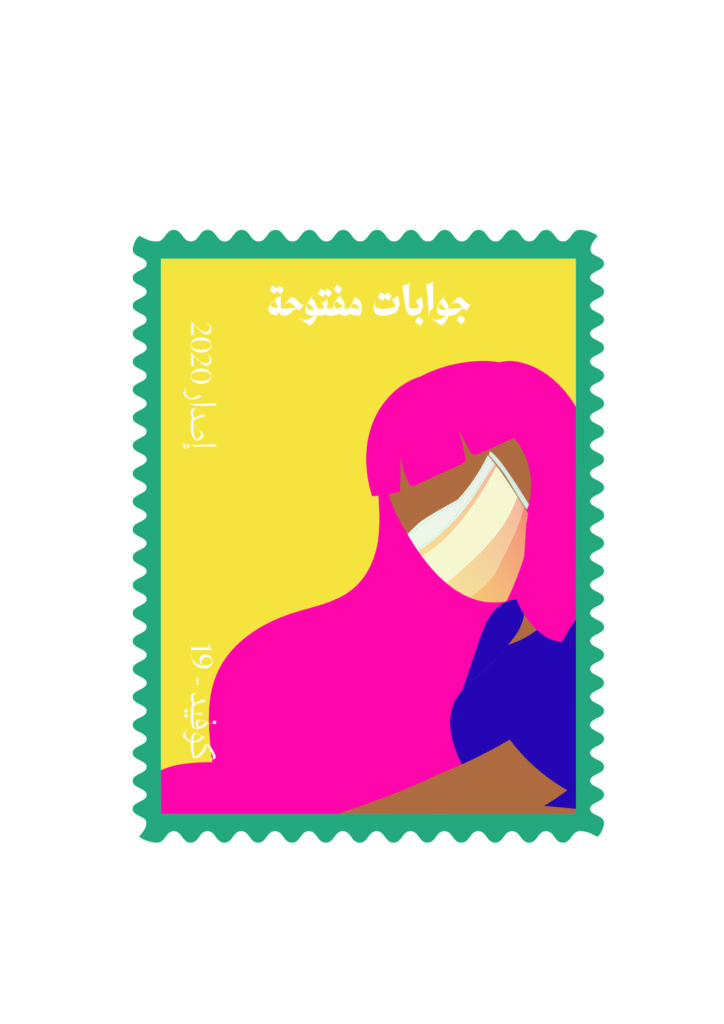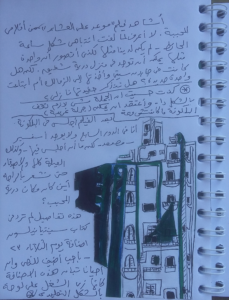نص مُجهل
قبل فترة قصيرة، استمعت إلى تسجيل لفتاة بحرانية تحكي عن تعرضها للاغتصاب، واكتشفت بعدها أن اسمها زهرة الشيخ. ردود الأفعال تراوحت بين من عبر عن مساندته ودعمه لها، من شكّك في مصداقيتها وقام بلومها على ما تعرضت له، ومن اكتفي بالصمت. كم شعرت حينها بالخذلان والخيبة والوحدة. كان من الممكن أن أكون في محلها بسهولة. من الممكن أن أكون في محلها في المستقبل، ولن يكون هناك من ألجأ له. زهرة استحقت حينها وتستحق اليوم أكثر بكثير منا جميعًا. خذلناها جميعًا.
لا أكتب هذا المقال لتحليل حراكاتنا المقاوِمة بمحاسنها ومساوئها، وإنما أكتبه لمجرّد التعبير عن خيبة ظنّي فينا، نحن من ندّعي معاداتنا ومحاربتنا للظلم والاستبداد والأبوية. أحاول أن أقوم بذلك بشكل نقدي، وذلك ليس تقليلا من أشكال مقاومتنا الحالية أو تفنيدا لشرعية أي حراك يحاول مقاومة الظلم والاستبداد، وإنما محاولة لممارسة المحاسبة الذاتية ودعوة للتفكير معا.
ما تعلمته من ردات الفعل تجاه زهرة هو أننا لا نمانع أن نمحي نضال نسائنا من مخيلتنا الاجتماعية، بكل أريحية وبكل سهولة. زهرة الشيخ، لِمَن نَسِيَ منّا أو تناسى من تكون، شاركت في نضالنا من أجل بحرين أفضل. تعرضت لعدة اعتقالات بسبب نشاطها السياسي في 2012، 2013، 2014، وحتى 2018. قضت شهورا من حياتها في السجن، بعضها مع ابنها الذي لم يتجاوز الستة شهور حينها. اعتقل زوجها الذي لا يزال في السجن، فهو محكوم لمدة 15 سنة كاملة. اضطرت للجوء إلى بريطانيا ولا زالت هناك. هل نسينا هذا كله؟
في التسجيل الصوتي لزهرة، روت عن تعرضها للاغتصاب من قبل شاب بحراني اسمه أيمن الغسرة، حين كانت في زيارة دينية للعراق. يأتي هذا التسجيل في سياق قيام عدد من النساء البحرينيات بالتحدث عبر تويتر عن تجاربهن المختلفة مع الاعتداءات الجنسية، ومن ثم مواجهتهن لردات فعل مختلفة قد تكون داعمة وقد تكون عنيفة وتوجه اللوم للضحية. إحدى هؤلاء النساء كانت زينب (أو آنيا)، وهي ناشطة نسوية تويترية بحرينية، تحدثت عن تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل إخوتها. تضامن معها الكثيرون وعبروا عن دعمهم وتصديقهم لها، وقامت زينب بشكر من دعمها وعبرت عن أسفها لكل امرأة تعرضت أو تتعرض لأمر مماثل. وأدّى هذا إلى انتشار الهاشتاق (#إلغاء_المادة_353) في الفضاء التويتري البحريني، وهي مادة في قانون العقوبات البحريني تعفي المغتصب من عقوبته إذا تزوّج من ضحيته. وقامت جمعية الشباب الديمقراطي البحريني بحلقة حوارية عن الموضوع عبر قناتها في اليوتيوب. في الحديث عن هذه المادة تحميلٌ للدولة جزءًا من المسؤولية، وعدم حصر هذه المسؤولية في المجتمع أو حتى في المغتصب لوحده. قد تكون هذه لحظة إيجابية، فهي محاولة لمقاومة عنف المجتمع والدولة معًا دون الفصل بينهما، وهي فعل مقاوم يمكننا البناء عليه.
ولكن، لماذا غاب هذا الدعم عندما تحدثت زهرة عمّا تعرضت له من اغتصاب؟ لماذا الصمت أو التشكيك؟ ولماذا لم نعُد نرى دور الدولة ومسؤوليتها في هذه الحالة؟ ما الذي اختلف؟ هل كان مزعجًا بالنسبة لبعض النسويات كون زهرة مناضلة ومعتقلة سابقة وزوجة معتقل؟ هل كان مزعجًا بالنسبة لبعض المعارضين للنظام كون مغتصب زهرة شاب بحراني وليس رجل الشرطة؟
أعتقد بأن جزءًا من المشكلة هو أن الكثير من محاولاتنا لمقاومة عنف المجتمع والدولة هي محاولات منفصلة، تركّز إمّا على نقد المجتمع أو الدولة، وتتعامل معهما ككيانان منفصلان، دون أن تحاول أن تكشف عن الطرق المختلفة التي يستخدمانها ليساعد كل منهما الآخر على تعنيفنا. يبدو لي أن الحراك النسوي البحريني التويتري، في شكله الحالي السائد، يركز على مقاومة عنف المجتمع دون الدولة، بينما تقوم المعارضة السياسية، بشكلها السائد، بالتركيز على مقاومة عنف الدولة دون المجتمع. يبدو لي أنه لا يوجد لدينا حراك يقاوم عنف الدولة والمجتمع دون فصل، على الأقل بشكل سائد ومنتشر ومستمر.
حسب فهمي للحراك النسوي في البحرين في شكله السائد، فهو لا يرى أي مشكلة في تركيزه على مقاومة الأبوية دون مقاومة النظام. يستخدم خوفه من عنف الدولة كعذر. قد يؤدي خوفنا إلى صمتنا أحيانًا، ولكنّي لا أعلم إن كان خوفنا يؤدي إلى استخدامنا لمنطق الدولة لتبرير عنفها تجاهنا. لا أعتقد أن هذا الخوف هو السبب الوحيد. أعتقد أن هذا الحراك النسوي السائد لا يرى الدولة مسؤولة أصلًا عن تعنيفنا كنساء، ولا يرى الضرر في إخلاء الدولة من هذه المسؤولية، ولا يرى أن مقاومتنا للأبوية تحتم علينا أن نقاوم النظام أيضًا. حين يحاول البعض نقد أي من النسويات على مواقفهنّ من الدولة، قد يتخذن وضعية دفاعية، بدل مراجعة أنفسهن وتحمّل المسؤولية، وقد يتعذّر البعض منهن لكونهن يقمن بعمل المستطاع أو الممكن.
هنا، أطرح بعض التساؤلات للنسويات:
لماذا لا تردن أن تحاسبكن نساء مجتمعكن؟ لماذا تقمن بالعمل الذي تقمن به ومن أجل من؟ ولماذا لا يزعجكن كون عملكن لا يحاسب كل من كان مسؤولا عن تعنيفنا لجندرنا وجنسانيتنا؟ وأخيرًا، ألا يجب أن يقوم نضالنا بتوسيع ما هو ممكن بدل الرضوخ للممكن الحالي؟
أما بالنسبة لمعارضتنا للدولة، في الشكل السائد لهذه المعارضة، فهي تعتقد بمحاسبة الدولة دون المجتمع على العنف الذي نتعرض له، وهي لا ترى أي ضرر في حصر نضالها ضد الدولة فقط، ولا ترى أي ضرر في النظام الأبوي الذي يحكم مجتمعنا. يتخذ جزء كبير من العمل المعارِض في البحرين شكل العمل الحقوقي، وهو لم يبدأ في عام 2011، ولكنه انتشر بشكل كبير منذ ذلك الوقت، قد يكون ذلك بسبب التضييقات على الأشكال الأخرى من العمل السياسي، وقد يكون كمحاولة لتوثيق الانتهاكات التي اشتدت حينها. رغم أن الكثير ممن اشتغل ويشتغل في هذا المجال هم من النساء، كزينب الخواجة، مريم الخواجة، ابتسام الصايغ، نضال السلمان، وغيرهن ممن يعملن في العلن أو خلف الكواليس. رغم ذلك، أتساءل، مَن يسيطر على الكثير من قرارات واتجاهات هذا العمل الحقوقي بشكل خاص والعمل السياسي المعارِض بشكل عام. في الفيلم الوثائقي الذي تحدثت فيه نجاح يوسف عن تجربتها في السجن وتعرضها للاغتصاب من قِبَل رجال الشرطة، يقوم رجل حقوقي بحراني بالتحدث معها على الهاتف لتوثيق هذا الانتهاك (25:10 – 26:30). قد تكون مجرد إعادة تمثيل لما حدث، ولكن حتى في إعادة التمثيل هذه، أتساءل إن كانت نجاح مرتاحة في سرد هذه التفاصيل لرجل، وإن كان حقوقيًّا، وأتساءل إن كان ذلك يُصعّب على الناجيات الحديث عن تجاربهنّ. أما زهرة الشيخ، فحين تحدثت عن تعرضها للاغتصاب في التسجيل الصوتي الذي انتشر على تويتر، فقد قالت بأنه حين لجأت لبريطانيا، وحين طلبت المساعدة من المناضلين السياسيين والحقوقيين الموجودين هناك، لم يساعدها أيّ منهم بالشكل الكافي، رغم أنهم يكتبون البيانات عن انتهاكات الدولة تجاهها. ونتيجة لذلك، اضطرت زهرة للبقاء في الشارع مع ابنها الصغير.
هنا، أود طرح هذا التساؤل للمعارضة والحقوقيين منهم بالذات: من أجل من تقومون بعملكم الحقوقي؟ لماذا تكتبون البيانات عنّا إن كنتم ستردوننا حين نلجأ لكم للمساعدة؟
هذه التساؤلات ليست هجوما على أحد، ولكنها دعوة للتفكير والمحاسبة الذاتية. إن كنّا جميعا نريد أن نعمل من أجل بحرين أفضل، ألا يجب علينا أن نحاسب كل من كان مسؤولا عن الوضع القائم؟ لماذا لا نمارس هذه المحاسبة عندما تتحدث امرأة عن تعرضها للاغتصاب؟ لماذا لا نزال نوجه اللوم لها؟ لماذا لا ندعم النساء إلا حينما يكون الأمر سهلا؟ لماذا لا ندعمهن إلا بشروط؟ أندعمهن فقط حين يكون المعتدي شخص شرير جاء من الفضاء؟
لا نود محاسبة أنفسنا، ونتحاشى النظر أو الحديث عن الاغتصاب حين يجب علينا الاعتراف بالذنب والمساهمة في ثقافة الاغتصاب هذه. الاغتصاب، كما أفهمه، ليس حدثًا عابرًا خارجًا عن سياقه. المسؤول عنه ليس المغتصِب لوحده. اعترافنا بذلك لا يعفي المغتصب من مسؤوليته، وإنما يحمّل كل من كان مسؤولًا مسؤوليته أيضًا، وذلك يتضمن كل من ساهم في خلق بيئة تجعل من وجود الاغتصاب ممكنًا. فالدولة مسؤولة، وكذلك المجتمع.
الدولة هذه هي التي تشرع الاغتصاب في المادة 353 من قانون عقوباتها. وهي نفسها التي تعتدي شرطتها علينا وعلى أحبابنا، في الشارع والبيت ومركز الشرطة والسجن، اعتداءً لفظيا وجسديا وجنسيا، وتعاملنا بشكلٍ مهينٍ لكرامتنا ومُمحٍ لإنسانيتنا. والدولة هي التي تحكم على أحبابنا بالإبعاد عنا بالسجن لسنوات طويلة مما يجعلنا في موقف صعب دون أحد نلجأ له ليحمينا. ومن ثم تجبرنا على الهرب واللجوء بعيدًا أكثر عن أحبابنا بعد سنوات من تعرضنا لعنفها ومخافة استمرار ذلك العنف.
والمجتمع هذا هو الذي لا يعترف بنضالنا من أجله كنساء، ليس بالشكل الكافي، على الأقل. هو الذي يشعرنا بالعار وبالذنب حين يتم الاعتداء علينا من قبل أي كان، رجل الشرطة أو أخينا أو أخو الشهيد، لا يهم، فنحن دائما من لم نأخذ احتياطاتنا ونحن الملامين أولا وأخيرا. هذا المجتمع هو الذي يعتقد أن لا ملكة لنا على أجسادنا كنساء، وأن له الحق في التحكم في طريقة لبسنا، ويعتقد أن طريقة لبسنا مبررٌ للاعتداء الجنسي علينا، ويعتقد أن ممارساتنا الجنسية التي نمارسها بحريتنا هي مبررٌ أيضًا للاعتداء علينا. هذا المجتمع هو الذي لا يتردد في شيطنتنا حينما لا نعيش حياتنا حسب القواعد والمعايير التي يضعها لنا. هذا المجتمع الذي لا يرى أي مشكلة في استخدام صورنا كأداة لابتزازنا. والمجتمع هذا هو الذي يستخدم احتمالية كوننا مخبرات كعذر قبيح للتستر على اغتصابنا، حتى حين نكون لاجئات ومحكومات غيابيا وزوجات معتقلين.
لا أتكلم عن المجتمع كأنّي خارجه. فأنا منه وفيه، وأنا مسؤولة أيضًا. كلنا مسؤولون وليس المغتصب مسؤولا لوحده، حتى وإن اختلفت درجات وأشكال هذه المسؤولية.
أعتقد أننا نستحق حماية من عنف الدولة والمجتمع معًا، لا أحدهما دون الآخر، وأننا نحتاج فكرًا وحراكًا سياسيًّا يرى أهمية مقاومتهما معًا دون التغاضي عن أحدهما خوفًا من الآخر. هذا ما يمكن للنسوية المقاومة للنظام والأبوية أن تسمح لنا بالقيام به.
قد لا نستطيع إسقاط النظام ولا الأبوية اليوم، ولكننا نستطيع أن نقوم بالعمل الذي سيؤدي إلى ذلك غدًا، لا العمل الذي يعيد إنتاج هذه الأنظمة. نستطيع أن نقاوم هذه الأنظمة وأن نسرد هذه المقاومة لنتذكرها ونتعلم منها. كما نستطيع أن نحاسب أنفسنا بشكل دائم ونسمح لمن نقوم بعملنا من أجله أن يحاسبنا من أجل أن نقوم بعملٍ أفضل. ونستطيع أن نسيّس عملنا النسوي وأن نعترف بأن السياسة جزء أساسي من هذا العمل، وأن لا عمل نسوي ما لم يكن سياسيا، وأن أي عمل نسوي خالٍ من السياسة هو عمل مشوه وناقص، وقد يكون مضرّا أيضا لأنه لا يحاسب كل من كان مسؤولا عن تعنيفنا لجندرنا وجنسانيتنا. لا أعلم إن كانت تبدو هذه مهمّة صعبة أو كبيرة، ولكن ما قد يسهلّها هو معرفتنا بأننا لا نحتاج أن نبدأ من الصفر. لدينا تاريخ من النضال والحراك المناهض للدولة من ضمنه حراك نسائي، لدينا نساء قامت في الماضي وتقوم الآن بممارسات من أجل النجاة والمقاومة في حياتهنّ اليومية وفي دوائرهنّ الخاصة، ولدينا حاليّا حراك نسوي وحراك مناهض للنظام، كما أن لدينا حراكات نسوية ومقاوِمة في المنطقة والعالم كله، في الماضي والحاضر. يمكننا أن نبني على كل هذا.